رواية غير قابل للحب الفصل الخامس والثلاثون 35 بقلم منال سالم
رواية غير قابل للحب الجزء الخامس والثلاثون
رواية غير قابل للحب البارت الخامس والثلاثون
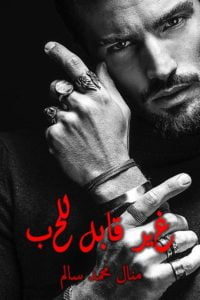
رواية غير قابل للحب الحلقة الخامسة والثلاثون
الفصل الخامس والثلاثون – الأخير
شعرت بقوة المحبة الطاغية تجتاحني، وحلقت بوجداني إلى ما وراء الوراء، كأني سافرت إلى فضاء بعيد، كنت أهيم عشقًا في نظراته، أسبح ابتهاجًا مع ابتساماته العذبة، آملت أن حلمي البسيط تحقق أخيرًا؛ لكن قساوة الحياة سلبتني اللحظة المميزة، لم أكن قد استفقت بعد من غيبوبة المشاعر الحسية العميقة حتى وجدت “فيجو” قد تحول للنقيض: إنسان آلي، صلد، متحجر القلب، وغير لين الطباع. تركني وأنا بحاجة لضمته، أبعدني عنه وأنا في لوعة لاقترابه المحسوس، ليلبي نداء عمله غير مبالٍ بحالتي النفسية المحطمة.
عندئذ فرت دمعة حبيسة من طرفي، فما اعترف به -وأنا في قمة استسلامي- قد قيل على سبيل التسلية، واللهو، واللعب بمشاعري المرهفة، هو فعل ذلك باحترافية مدروسة لئلا أضجره بكآبتي الزائدة عن الحد، وأفسد عليه نهاره، خاصة مع تعليمات الطبيب بالبعد عن الضغوط النفسية الموترة للأعصاب، شعرت بضربٍ من الاستياء العميق يصيب دواخلي، وأدركت من جديد أنه لن يتغير، فهو لا ينتمي لفئة المؤمنين بالحب أو أي شيء له صلة بالأحاسيس والعواطف، وما كان بيننا من انسجام واشتياق انقضى بمجرد انطفاء ذروة الرغبة، حيث عاد إلى ما كان عليه من الجدية والجمود.
جففت وجنتي بحركة سريعة من إصبعي قبل أن يلاحظ السائق حزني، ورغم اختبائي خلف نظارتي القاتمة، إلا أني شعرت بسهولة اكتشاف ما أمر به من ضيق وتعاسة، التفت أنظر إليه عندما تكلم في الهاتف:
-سنصل بعد قليل، اتبعنا.
سألته بعد نحنحة سريعة:
-ما الأمر؟
أبعد الهاتف عن أذنه، ونظر إلى انعكاس وجهي عبر المرآة، ثم أخبرني في نبرة رسمية:
-لا تقلقي سيدتي، أنا أعلم أفراد الحراسة بمسارنا.
منحته هزة من رأسي وأنا أرد:
-حسنًا.
تابعت الطريق من زاويتي بنظراتٍ شبه شاردة، كذلك ظللت فاقدة للتركيز معظم الوقت، حتى وأنا مدعوة كضيفة استثنائية في حفل غداء السيدة “كاميلا” الصاخب، اتخذت الصمت رفيقًا، بقيت هادئة، شاردة، تطرأ على ملامحي علامات العناء. دنت مني صاحبة المكان تسألني في اهتمامٍ:
-هل أنتِ بخير؟
رفعت نظري إليها، وقلت بابتسامةٍ منمقة:
-نعم.
تأملتني بغير اقتناعٍ، لم تكن لتتركني أمضي دون أن تحصل على ما يشبع فضولها، جلست إلى جواري بالحديقة، وأردفت في مكرٍ، كأنما بهذا تحاول سبر أغواري:
-تبدو عليكِ التعاسة.
ادعيت كذبًا لأهرب من حصارها السخيف:
-أشتاق لعائلتي، ولموطني.
تنهدت مليًا، وأبدت تعاطفًا زائفًا وهي تخبرني:
-كلنا مثلك، تمر علينا لحظات لهفة وحنين.
أتبعت ذلك بمسحة رقيقة على كفي براحة يدها، فابتسمت مجاملة، وأرحت ظهري للخلف لأغوص في المقعد، وأنا بالكاد أناضل لأبقى متجاوبة مع من حولي، فقد تمكن الإنهاك من جسدي، وجعلني شبه خاملة، ربما كان من الأفضل أن أعود إلى القصر بدلًا من التجول هنا وهناك. نسمة من الهواء العليل هبت علي جعلت أنفي يتحفز، في البداية لم أعر الأمر اهتمامًا، إلى أن أحسست بوخزة تضرب أسفل معدتي، قبل أن يراودني هذا الشعور المزعج بالغثيان، اعتدلت جالسة، وتساءلت في ضيق منعكس على وجهي:
-ما هذه الرائحة؟
اندهشت “كاميلا” لسؤالي، وردت بآخر في تحيرٍ:
-أي رائحة؟
أخبرتها وأنا أدور برأسي في المكان محاولة كشف مصدرها المنفر:
-أشم رائحة غريبة ومزعجة.
اتجهت أنظار “كاميلا” نحو الصغار الذين بدأوا في الركض من حولنا وهو يتناولون الشطائر، ضحكت في لطافةٍ لمرحهم الممتع، وأخبرتني وهي تشير إليهم:
-ربما سكب أحدهم شيئًا هنا، سأطلب من الخدم تنظيف المكان وترتيبه…
ثم اقترحت علي حين وجدتني أضع إصبعي على أنفي لأقلل من هذا الشعور المتزايد:
-لما لا نجلس بمكانٍ آخر؟
وافقت في التو ودون تفكيرٍ:
-حسنًا.
نهضت من مكاني وأنا أوزع ابتسامات رقيقة على السيدات الجالسات في محيطنا، إلى أن تخطيت الحديقة، وولجت إلى داخل البهو، هناك زاد إحساسي بالانقباض والاختناق، كما تضاعف الوخز في معدتي، وراح كامل جسدي يتعرق، وما زاد الطين بلة أن دوار عجيب لف رأسه وكاد يطيح بها. هرعت نحو أقرب قطعة أثاث أستند عليها، استعدت توازني بعد لحظةٍ؛ ولكني مِلت للأمام، ويدي موضوعة على فمي، تجشأت بصوتٍ خفيض قبل أن أقول:
-لا أشعر أني بخير، معدتي تئن من الألم.
لحقت بي السيدة “كاميلا”، بدا القلق ظاهرًا عليها، علقت مشيرة بيدها:
-سآتي لكِ بدواءٍ مناسب.
اعترضت في صوتٍ واهن:
-لا أظن آ…
لم أتم جملتي بسبب رغبتي العارمة في التقيؤ، سألتها بأنفاسٍ غير منتظمة:
-أين الحمام هنا؟
أشارت نحو الرواق قائلة في خوفٍ:
-هناك..
أمسكت بيدي، وتابعت:
-سآخذك إليه.
كنت ممتنة لكونها تدعم مشيي غير المتزن، سرت معها إلى أن وصلت الحمام، حينها فقط أفرغت ما امتلأت به معدتي، بدوت في حالة مزرية، مقززة، نظرت إلي السيدة “كاميلا” بقلقٍ متعاظم، وسألتني وهي تناولني المنشفة القطنية:
-يا إلهي، سيدة “ريانا”، هل أنتِ بخير؟
استندت على حافة الحوض، وأبقيت على رأسي مطأطأ، نظرت إليها بوهنٍ، ثم تكلمت في إعياءٍ واضح:
-لا أعرف ما الذي يحدث لي!
تكرر الأمر من جديد، وتقيأت بألمٍ حتى شعرت بخواء معدتي، غسلت بعدها وجهي، واعتذرت عن الفوضى المقرفة التي تسببت بها، تفهمت السيدة “كاميلا” وضعي الطارئ، وعاونتني خلال خروجي من الحمام قائلة بودٍ:
-استندي على ذراعي.
أصابني دوار أعنف، فتشبثت بها لئلا أفقد توازني، ثم قلت:
-أشكرك.
ذهبت بي إلى المطبخ، فجلست بتؤدة على أحد المقاعد المرتفعة، سألتني وهي تشير للخادمة بيدها:
-هل تعانين من البرد؟
هززت كتفي قائلة:
-ربما.
تحدثت بشيء إلى الخدامة بعدما اقتربت منها، ثم عاودت الحديث إلي باهتمامٍ:
-سأعد لكِ شيئًا طبيًا سيهدئ من اضطراب معدتك.
استحسنت اقتراحها، وأرحت مرفقي على السطح الرخامي الذي أجلس ملاصقة له، بدأت أسحب أنفاسًا عميقة لفظتها على مهلٍ حتى استعدت قدرًا بسيطًا من عافيتي، جاءت إلي السيدة “كاميلا” وهي تحمل فنجانًا خزفيًا مملوءً بمشروبٍ عشبي، أعطتني إياه قائلة ببسمة مهذبة:
-اشربي ذاك المشروب، إنه جيد.
تناولته منها، ورددت بعد زفرة بطيئة:
-لا أبدو بخير هذه الآونة.
ارتشفت القليل، فكان المذاق قويًا، امتعضت ملامحي، وأكملت رغم هذا تجرعه. رفعت نظري نحو السيدة “كاميلا” عندما خاطبتني في حرجٍ:
-اسمحي لي أن أسألك شيئًا خاصًا.
أبديت ترحيبي قائلة:
-تفضلي.
بدت خجلى وهي تميل علي لتسألني بصوتٍ خافت:
-هل تفقدتِ موعد زائرتك الشهرية؟
سعلت أولًا من الصدمة، واهتز الفنجان في يدي، فتناثرت عدة قطراتٍ من المشروب، خفضت يدي، وحملقت ناحيتها وقد حلت بي صدمة لحظية، ثم هتفت بغير تصديقٍ:
-ماذا؟
تابعت بضحكةٍ ماكرة وهي ترمقني بهذه النظرة الشقية:
-فإذ ربما يكون هذا…
قاطعتها في ذعرٍ يدعو للريبة:
-لا يمكن أن يحدث.
أشارت لي بكلتا يديها وهي تستطرد باستغرابٍ:
-اهدأي، ذاك شيء وارد الحدوث بين الأزواج.
قلت في إصرارٍ رافض:
-مُستحيل.
شردت نظراتي عنها، وأخذت أتكلم بصوتٍ مهتز:
-أنا ألتزم بأدويتي و…
بهدوءٍ واضح عليها قاطعتني سائلة:
-حسنًا، لكن هل تذكرين متى جاءتكِ آخر مرة؟
رحت أفرك مقدمة رأسي لهنيهة، ثم قلت بعد تفكيرٍ سريع:
-إنها غير منتظمة.
شاب نبرتها الحماس وهي تخبرني بلؤمٍ:
-يمكننا التأكد بطريقة أخرى سريعة.
تحفزت في جلستي، وسألتها:
-كيف؟
أشارت بسبابتها موضحة بتشوقٍ مغاير للخوف الذي استبد بي:
-لدي هنا في حمامي بالأعلى اختبار الحمل المنزلي، عادة احتفظ بمجموعة في حال أن أصابني الشك، سآتي لكِ بواحدٍ.
لم تترك لي المجال للاحتجاج، انطلقت في التو تجاه الدرج لتحضره، فوضعت يدي أعلى رأسي أدمدم في توجسٍ شديد:
-اختبار حمل منزلي! يا إلهي، أرجو ألا يكون ذلك صحيحًا.
…………………………………………….
شبكت كفي يدي معًا، ودارت برأسي كل الهواجس والخواطر غير المحمودة، اعتصرت ذهني اعتصارًا لأتذكر متى زارتني ضيفتي الشهرية، فلم أتمكن من تحديد الموعد، بدت كل الشواهد تشير إلى احتمالية حدوث الحمل، خاصة مع وجود بعض الأعراض الفسيولوجية التي كنت أتجاوز عنها، حيث ظننتها ترجع لحالتي النفسية المتقلبة. عادت إلي السيدة “كاميلا” بعد دقائق وهي شبه تقفز في خطاها، أبرزت العلبة نصب عيني، وقالت بحماسٍ متقد:
-يمكنكِ استخدام هذه، تصلح للاستعمال في أي وقت، ونتائجها إلى حدٍ كبير دقيقة.
أخذتها بترددٍ من يدها، وتطلعت إليها في نظرة طويلة شاردة، وجدتها تدفعني برفقٍ نحو الحمام وهي تهمس لي:
-هيا، سأنتظرك هنا.
همهمت بين جنبات نفسي وأنا أشعر بهذا الخفقان القوي في صدري:
-ليته يكون كذبًا!
اتبعت التعليمات المدونة على ظهر العلبة، بالطبع كان الاختيار الأنسب للحصول على نتائج أفضل في مطلع النهار عند الاستيقاظ؛ لكن لكوني على عجلة من أمري، فاضطررت لاستخدامها بغير توقيتها الملائم، لعل وعسى تأتي النتائج مثلما أرجو. نادت علي السيدة “كاميلا” من الخارج:
-عزيزتي “ريانا”…
بقيت صامتة أنظر إلى الاختبار بعينين متسعتين، فظلت تسألني من خلف الباب الموصود:
-كيف الحال؟
قلت وأنا ألعق شفتي:
-لحظة.
في هذه الثواني الفارقة كان الفضول عاتيًا، سواء من ناحيتي أو من تجاه السيدة “كاميلا”، كلتانا تريدان بشدة معرفة النتائج، مع فارق ردود الفعل. حبست أنفاسي، ووضعت يدي على فمي أنتظر مدلول الاختبار، وعاصفة من الرهبة تنتظر الهبوب في أي لحظة!
…………………………………………..
التبلد، اللا تعبير، وأمارات الجمود كانوا ظاهرين على وجهي عندما فتحت باب الحمام، سددت نظرة خاوية للسيدة “كاميلا” التي كانت لا تزال في انتظاري بتشوقٍ، أقبلت علي تسألني في لهفة وهي تضم يديها معًا أمام صدرها:
-ما الأخبار؟
رفعت الاختبار في مرمى نظرها لتراه بوضوح وأنا أقول بلا حماسٍ:
-إنها شرطتان، هل هذا يعني أني… ؟!!
صرخت من الفرحة، وصفقت بيدها مهللة:
-يا إلهي، أنتِ حامل، سيسعد الزعيم “مكسيم” كثيرًا بذلك الخبر، هو ينتظر حفيده المرتقب منذ زمن.
أخذتني في حضنها، وظلت تبدي سعادتها للنبأ السار فقالت:
-لا أصدق، البشارة كانت عندي..
استطعت سماعها وهي تقول في انتشاءٍ:
-حتمًا سأنال مكافأة سخية.
لم تبدُ مهتمة بمطالعة حالتي الواجمة، فهمست بتبرمٍ مستاء من بين أسناني المضغوطة:
-أنا حامل، وهي تفكر في المكافأة، اللعنة!
رأيتُ كيف شطحت بأحلام يقظتها وهي تواصل الحديث:
-خبرٌ كهذا سيزيد من قوة عائلة “سانتوس”، خاصة إن كان الطفل القادم ذكرًا، سيرث إمبراطورية العائلة العريقة.
نظرت لها شزرًا، أي ميراث هذا الذي سيرثه الطفل؟ إنها لعنة دموية تهلك صاحبها! مدت كفها نحو يدي، سحبتها إليها واحتضنتها بين راحتيها، ثم رمقتني بهذه النظرة الذليلة قبل أن تستأذنني:
-ما رأيك أن نخبرهما معًا؟ لا أريد تفويت فرصة نيل رضا الزعيمين “مكسيم” و”فيجو”.
ضقت ذرعًا بما تفعله، فصحت في صوتٍ حاد وأنا أنتشل يدي منها:
-سيدة “كاميلا”، اسمعيني من فضلك.
تسمرت في مكانها تسألني في تعجبٍ مندهش:
-هل تريدين شيئًا؟
قلت بجدية بحتة:
-نعم.
أمسكت بها من ذراعها، وسحبتها للجانب لأخاطبها بصوتٍ شبه خافت لكنه ما زال جادًا:
-من فضلك لا تخبري أحدًا…
اكتسب وجهها بعلامات الاستغراب، فتابعت مشددة:
-لا أريد أن يعلم أي شخص بمسألة حملي.
سألتني في استرابة وهي ترمقني بنظرة متشككة لم أسترح لها:
-لماذا؟ هل هناك خطب ما؟
وقتئذ، وتحت وطأة المفاجأة، لم أعرف سبيلًا للمراوغة، أو تلفيق حكاية جيدة التصديق، لهذا أطلعتها بتلعثمٍ:
-لو علم “فيجو” بحملي…
بدت متأهبة الحواس لسماع البقية، فتابعت وأنا أضع يدي على بطني:
-سيقتل الجنين.
شهقت صائحة في صدمةٍ:
-ماذا؟
أومأت برأسي لأؤكد لها جدية تهديده المزعوم، فانزلقت تسألني بوجهٍ شاحب:
-هل.. هل قمتِ بخيانته؟
بهتت ملامحي لاتهامها الصريح، وسددت لها نظرة متسعة وذاهلة، قبل أن أنفي في التو هذه الكارثة بشدة:
-لا، ما هذا الكلام؟ لم أقم مُطلقًا بخيانته، إنني زوجة وفية.
ردت بنظرة مُدينة:
-كلنا نخطئ عزيزتي.
دافعت عن نفسي بضراوةٍ:
-لست أنا هذه، لكنه أمرني ألا أحمل، وهددني إن فعلت فسيقضي على ما ينمو في أحشائي.
خفضت من بصرها لتحدق في يدي القابضة على بطني، ثم علقت:
-لا أعتقد هذا، فهم يقدسون الجو الأسري.
محاولة إقناعها بحقيقة ما أقول بدا عسيرًا، لهذا لجأت لحجة أخرى رجوت أن تنطلي عليها، فأخبرتها:
-نعم؛ لكنه يريد التوسع في حجم إمبراطوريته، ولا يرغب في الانشغال بغير ذلك حاليًا.
حدجتني بنظرة ذكية غير سهلة وهي تعقب:
-عذرًا سيدة “ريانا”، الرجال في جماعتنا لا يهتمون برعاية الصغار إلا حين يصلون للسن المطلوبة للانضمام لصفوفهم، فلا أظن بوجود مشكلة، إلا كما أخبرتكِ، أنتِ قمتِ بالتورط في شيء مشين، وتريدين التغطية عليه.
رفعت إصبعي في وجهها أحذرها بحنقٍ:
-لن أسمح لكِ بمثل هذه الاتهامات، هذا الجنين من صلبه.
قالت بغير ابتسامٍ، ونظرتها الملامة مصوبة نحوي:
-وأنا أصدقك، كما أن تحاليل الـ DNA كفيلة بإثبات أي شكوك عزيزتي إن كنتِ تخشين أي اتهامات.
محاولة مجاراتها في التوضيح والتفسير كان منهكًا، لذا أنهيت مبرراتها غير الضرورية بقولي الأخير:
-حسنًا، سأخبره؛ لكن ليس الآن.
منحتني نظرة أخرى لئيمة قبل أن تنطق بما اعتبره نصيحتها الثمينة:
-ولكن لا يمكن إخفاء هذا الأمر.
بلعت ريقي ورجوتها بلطفٍ:
-أعلم، أريد أن أوفق أوضاعي أولًا، وأمهد السبيل لذلك، فلا داعي لإخبار أحدهم.
لم تبدُ مقتنعة بطلبي، فقالت كنوعٍ من التحايل على الموقف:
-حسنًا، كما تريدين، يمكنكِ أن تستريحي قليلًا ريثما أعد لكِ شيئًا مفيدًا.
دفعتني برفقٍ من ظهري نحو الطريق المؤدي إلى الدرج وهي تقترح علي:
-ما رأيك بالصعود للأعلى؟ غرفتي مفتوحة لأجلك.
ابتسمت قائلة في رقةٍ ممتنة:
-أشكرك.
أخفيت وراء ابتسامتي الصغيرة توتري المتزايد، حتمًا لن تصمت هذه المرأة وتضيع الفرصة -المادية- من يدها، راقبتها وهي تعود إلى المطبخ، ووضعت يدي على حافة الدرابزين تمهيدًا لصعودي؛ لكني لم أتحرك من موضعي، ظللت واقفة للحظات، أفكر بعمقٍ فيما يجب فعله للتعامل مع أزمتي الطارئة، فأنا على يقين تام بأن “فيجو” لن يتردد للحظة في التخلص من الجنين كعقابٍ مؤلم لي لمخالفتي تعليماته، وأنا شهدت على عنفه المفرط لأكثر من مرة، إنه لا يرحم أحدًا! لذا أنا مرغمة على إيجاد حل فوري لمعضلتي الوخيمة. اشتدت أناملي على الحافة وقد جال فجأة بخاطري فكرة متهورة، نطقتها في هسيسٍ مصحوبٍ بالعزم:
-لما لا أهرب قبل أن تكتشف هذه المسألة؟!
تلفت حولي متسائلة في تخبطٍ:
-ولكن كيف سأفعل ذلك؟
كورت قبضتي الأخرى ولكزت بها جبيني وأنا أحفز نفسي:
-هيا فكري “ريانا”، تحتاجين للتصرف بسرعة، لا وقت لإضاعته، فالسيدة “كاميلا” ستعلمه في أي لحظة.
لمحت إحدى الخادمات وهي تأتي من ردهة ضيقة مجاورة لسلم الدرج، تعلقت نظراتها بها وأنا أراها تضبط مريلتها البيضاء على ثوبها الرسمي الأسود، تتبعتها بنظراتي إلى أن مرت بجواري لتباشر عملها، أوحى تواجدها غير المتوقع بفكرة أخطر بعدما توارد على ذهني عشرات الخواطر، لما لا أتنكر في زي واحدة من الخدم؟ خاصة أن السيدة “كاميلا” تستعين بعدد كبير في كل مرة تقيم فيها حفلًا، ارتسمت ابتسامة سعيدة على وجهي وأنا أقول بثقة:
-هذا هو الحل.
…………………………………………………
في التو تسللت إلى مخدع الخدم في الخلفية، ألقيت نظرة عابرة لأتأكد من عدم متابعة أحدهم لي، واربت الباب بعدما ولجت للداخل، ومسحت المكان بنظرة سريعة فاحصة، بحثت خلالها عن موضع خزانة الثياب، حيث يتم الاحتفاظ بثياب عمل أخرى بديلة لاستخدامها عند اللزوم، حددت مكانها، واتجهت إليها بخطواتٍ متعجلة، فتحت الضلفة، واختطفت طقمًا لي. هرعت لتبديل ثيابي بملابس الخدم، وتأكدت من تغيير تسريحة شعري فأطلقته لأخفي بخصلاته معالم وجهي.
تذكرت أني تركت حقيبة يدي بالخارج، وذهابي إلى هناك يعني كشف أمري، وأنا لا أريد ذلك، توترت ولعنت بصوتٍ خفيض مرددة لنفسي:
-أنا بحاجة للمال لأدفع ثمن سيارة الأجرة، ما العمل الآن؟!!
كادت خيبة الأمل تصيبني لولا أن رأيت حقائب الخدم معلقة خلف الباب، لم أفكر مرتين، تحركت ناحيتهم، وفتشت فيهم تباعًا، وقمت باقتراض المال منهم، تركت ملحوظة ورقية صغيرة اعتذر فيها عن سرقتي الصغيرة، وأضفت مؤكدة:
-سأرد النقود لاحقًا.
جاء الجزء الأهم في خطتي العاجلة، كيفية تجاوز أفراد التأمين والحراسة، والخروج من الباب الرئيسي دون أن يشك أحدهم في أمري، بقيت واقفة في مكاني أحاول تدبر الوسيلة الفعالة، لحظي السعيد جاءتني النجدة من السماء، فقد نادت خادمة ما من ورائي:
-أنتِ.
التفت إليها بتوترٍ متوقعة أن تتعرف إلي؛ لكنها لم تكن تنظر تجاهي، بل كانت عيناها مرتكزة على عدة أكياس للقمامة وهي تأمرني:
-خذي هذه للخارج، واذهبي من الممر الخلفي.
سألتها وقلبي يدق من الخوف:
-أين هو؟
آنئذ استدارت متطلعة إلي بنظرة نارية، جعلت قلبي يهوى في قدمي، توقعت أن تكون قد تفقهت لهويتي؛ لكنها دنت مني هاتفة في تذمرٍ:
-يا إلهي، كيف تخرجين بهذه الهيئة؟ ألم نشدد على وضع القبعة وجمع الشعر؟
تلقائيًا رفعت يدي على خصلات ألمسها، واعتذرت منها:
-آسفة، أنا جديدة هنا.
نفخت في تأفف، وتابعت بحدةٍ:
-لا تتجولي وشعرك طليقًا، اعقديه، ثم ارمي هذه القمامة بالخارج.
تنفست الصعداء لجهلها بي، وقلت في طاعة وأنا أنكس رأسي:
-سأفعل، لكن أين الممر؟
بخطاها العصبية تقدمتني صائحة في غير صبر:
-احضري القمامة.
فعلت مثلما أمرت، وتركتها تقودني إليه بابتسامة منشرحة أخفيتها في الحال وهي تستطرد مشيرة للأمام:
-أترين هذا الدرج؟
أومأت برأسي، فأكملت:
-هو على جهة اليسار، ستجدين ممر الخروج معبدًا بحجر أبيض.
اكتفيت بإيماءة مقتضبة من رأسي قبل أن أبدأ سيري تجاه منفذ هروبي المتاح، اتبعت تعليمات الخادمة، ومشيت على الممر حتى وصلت إلى البوابة الخلفية، حافظت على رباطة جأشي، ورسمت طابع الجدية المتجهمة على ملامحي، وهناك سألت أحد أفراد الحراسة عن مكب النفايات، فسمح لي أحدهم بالمرور دون شكٍ.
ما إن ألقيت بالأكياس في الصندوق القريب، حتى أسرعت بالهروب في الاتجاه المعاكس باحثة عن سيارة أجرة، لمحت واحدة مرابطة على بعدٍ، فركضت إليها متسائلة بصوتٍ شبه لاهث:
-هل أنت متفرغ؟
ابتسم لي السائق، وقال مرحبًا:
-نعم سيدتي، أين تريدين الذهاب؟
فتحت الباب، وقفزت جالسة بالخلف وأنا أخبره في أنفاس لاهثة:
-اتجه بنا إلى موقف الحافلات.
…………………………………………..
شعرت بالراحة تتخللني وأنا أجد سيارة الأجرة تنطلق بي بعيدًا عن الجميع دون أن يتبعها أحد، فقط ألقيت أكثر من نظرة عبر الزجاجي الخلفي لأتأكد من هذا، انفرجت أساريري بعدما نجحت خطتي البسيطة، وأصبحت طليقة، كفكفت بكم ثوب الخدم حبات العرق المتجمعة في جبيني، وغصت أكثر في المقعد مستمتعة بنسائم الحرية التي اجتاحتني، كدت أتلذذ بمتعتي كاملة لولا أن سمعت السائق يقول:
-الطرد بحوزتي.
انقبض قلبي، وتحولت أنظاري تجاهه، فرأيته يخابر أحدهم عبر الهاتف، تساءلت مع نفسي بفضولٍ:
-أي طرد هذا الذي يتحدث عنه؟
راقبته بحذرٍ وهو لا يزال يتكلم، لن أنكر أن الهواجس راحت تدور في رأسي، خشيت من احتمالية القبض علي؛ لكني وجدته يحكي عن أمر آخر غير ما ظننت، فبدا الموضوع عاديًا، لذا لم أشغل بالي بشأنه، واسترخيت مجددًا إلى أن لمحت لافتة جانبية تشير إلى الطريق الفرعي المؤدي إلى موقف الحافلات بعد عشرات الأمتار، تأهبت في جلستي، وتوقعت أن يتبع السائق العلامات الإرشادية، للغرابة واصل الانطلاق بسيارته على الطريق السريع، فاندهشت لفعلته، وأخبرته في الحال بنظرة متعجبة:
-لقد فوت المدخل إلى طريق الحافلات!!
قال وهو ينظر لانعكاسي في المرآة:
-هناك آخر مختصر.
تمسكت باعتراضي القلق:
-ولكن…
قاطعني قبل أن أنطق بشيءٍ:
-لا تقلقي سيدتي، سأصل بك إليه، أنا أعرف الطرق جيدًا، وهذا الطريق أسرع.
قلت في تفهمٍ:
-حسنًا.
بالفعل ظهرت علامة إرشادية لطريق الموقف، فشعرت بالارتياح، توقعت أن ينحرف عند المدخل المؤدي إليه؛ لكنه تجاهله عن عمدٍ وزاد من سرعة سيارته، فصحت في ارتيابٍ:
-أنت تجاوزت ذلك أيضًا، إلى أين تذهب بي؟
لم يعلق السائق، فصار هدوئه المريب مُقلقًا ومخيفًا، سألته مرة ثانية في صوتٍ شبه متعصبٍ، ودقات قلبي ترتفع اضطرابًا:
-أتسمعني؟ أنت لا تتجه إلى الموقف!
أمرني بصوتٍ جاف، وهذه النظرة الشريرة مسلطة تجاهي:
-اجلسي بهدوء.
رددت بارتياعٍ آخذٍ في التصاعد:
-هذا لا يبشر بخير.
طرقت بيدي على الزجاج وأنا أهدر به:
-أريد النزول.
ضغط على دواسة البنزين ليزيد من سرعة السيارة وهو يخبرني بما قذف الرعب في كامل بدني:
-لن يحدث.
حينئذ أدركت أني وقعت في مأزق جديد، سألته والخوف معكوس في تعابيري:
-من أنت؟ وأين تأخذني؟
التفت ناظرًا إلي وهو يصرخ بي:
-اصمتي.
انتابتني حالة من الهياج، فأخذت أطرق بعنف على الزجاج وصوت صراخي المفزوع يجلجل:
-النجدة، إنه يختطفني.
أشهر سلاحه الناري في وجهي، فانكمشت على نفسي فزعًا منه، هددني بغير مزاحٍ:
-أقسم أن أقتلك إن لم تصمتي!
ارتجفت أكثر منه، أذعنت إلى تهديده الصريح، وسألته:
-من أنت؟
ألقى ناحيتي بصورة فوتوغرافية التقطتها بيدي المرتعشة، نظرت إليها وقد افترت شفتاي عن صدمة غريبة، عاودت النظر إليه عندما سألني:
-أتذكرين هذه؟
قلت بملامحٍ مبهوتة:
-“سيلفيا”!
رمقني بهذه النظرة الشيطانية قبل أن يعقب:
-جيد أنكِ لا زلتِ تذكريها.
سألته في جزعٍ:
-وما شأني بها؟
أجاب شارحًا بنبرة تطوي العداء الصريح:
-لقد أوصت إن اختفت ذات يوم أن أقوم بمهمة التخلص منك، لهذا واظبت على مراقبتك طوال المدة الماضية مع رفاقي، بالمناسبة أحدهم يعمل سائقًا لدى زوجك الحقير…
على الفور استحضر ذهني الكلمات المقتضبة للسائق الذي كان بصحبتي اليوم وهو يتحدث بالهاتف. انتبهت له وهو لا يزال يخبرني بتفاصيل خطته المعادية:
-رتبت كل شيء حتى أتحين الفرصة الملائمة لاختطافك، لم أتوقع أن يحدث ذلك اليوم؛ لكن الأمر تم بهروبك الغريب من هذا البيت، أنتِ ركبتِ سيارتي بإرادتك، وها أنتِ الآن بين يدي.
يا لحظي التعس! أأنجو من حفرة لأقع في أخرى أشد وطأة؟ حاولت تبرئة ساحتي من تورطي في أذيتها بقولي:
-صدقني، أنا لم أفعل لها شيئًا.
صاح في غضبٍ مهدد وهو يلوح بالسلاح:
-أنتِ المسئولة عن اختفائها.
انكمشت على نفسي، وتضاءلت للغاية، حتى أني ضممت يدي إلى صدري خشية أن يضغط على الزناد في أي لحظة، خاصة أن ملامحه الجامدة أكدت عدم تراجعه عن تنفيذ خطة اغتيالي، لاحت على زاوية فمه بسمة خبيثة حين استطرد مؤكدًا هاجسي المخيف:
-ولا تقلقي، سأجعل موتك سريعًا.
………………………………………………………….
أرعبتني اللحظات التالية، فقد كانت رغم سرعتها محفوفة بالكثير من الأحداث الخطيرة، في البداية رأيت فوهة السلاح مصوبة إلى جبيني، ونظرة السائق الشرسة مرتكزة علي؛ لكن قبل أن يقدم على قتلي حول ناظريه للجانب، وتساءل بزمجرة غاضبة:
-من هؤلاء؟
لم أجازف برفع رأسي لأستطلع الأمر أو حتى بسؤاله، فقد يفرغ في غمرة عصبيته الهائجة خزانة الطلقات في جسدي، ظللت ممددة على المقعد الخلفي أرتجف خوفًا، ارتطمت رأسي بالباب الملاصق لي في عنفٍ عندما انحرف بالسيارة فجأة، تأوهت من الألم، وحاولت إبعادها لكنه صدمني بقسوةٍ مما جعلني أحنيها نحو صدري وأضع ذراعي خلفها لحمايتها. سمعته يصيح بحنقٍ أكبر:
-اللعنة، إنهم موجودون في كل مكان!
ضغط على المكابح بغتةٍ فارتد كامل جسدي بقوة للأمام واصطدمت رأسي في عنف بالمقعد مما جعلني أخامر ما يشبه الإغماء جراء الضربة القاسية. تداخلت الأصوات، وتشوشت الرؤية لدي، فأصبحت بين اليقظة والهذيان، سمعت صوتًا مألوفًا يهدر بالقرب من محيطي:
-لا تتحرك.
جاء صوت السائق مرتفعًا ومسببًا لي الألم الشرس في عقلي المتلجلج عندما رد متسائلًا:
-من أنتم؟
أعقب ذلك سماعي لدوي طلقات نارية شديدة، وكأن السماء تمطر رصاصًا حيًا، فانهالت علينا من كل مكانٍ حتى تخللها نفس الصوت المألوف الآمر:
-توقفوا.
شعرت باهتزازة في جسدي، وبرأسي يميل للخلف، قبل أن تلطم وجنتي نسمات الهواء أو ربما صفعات رقيقة، لم أستطع تبين سبب الألم على وجهي، ظل الصوت يتردد بالقرب من أذني:
-اللعنة، إنها فاقدة للوعي.
قلت بصعوبة وسط نوبة هذياني:
-لا تقتلني، لم أؤذي أحدًا.
سرعان ما حطت سحب من الضباب فوق مداركي، وراحت تشدني معها نحو غياهب الظلام، بالكاد سمعت صوتًا يخترقها ليخبرني:
-“ريانا”، لا تخافي، أنتِ في أمانٍ معي.
أتبع ذلك ضمة غريبة احتوت جسدي المتراخي، ونفس الصوت يؤكد لي:
-لقد استعدتكِ حبيبتي.
………………………………..
للعذاب درجات، أكثرها ضراوة ووحشية أن تقع بين يدي من لا يؤمن بالرحمة، ظل إدراكي خاملًا إلى أن تيقظ عقلي بالتدريج، استفقت من سباتي الغريب وأنا أتمطى بذراعي في إرهاقٍ متكاسل. فتحت جفني ببطءٍ فكانت الرؤية مغبشة، أغمضتها من جديد ونظرت بعد لحظة بنصف عين إلى الجانب بعدما أملت رأسي على الوسادة، آَلَفت ما أبصرت، فأدركت أني بغرفة نومي، أحسست بالراحة والاطمئنان خاصة وأنا أرتدي ثياب نومي، فقد ظننت أني كنت أمر بحلم مزعج انتهى بإفاقتي؛ لكن ما لبث أن تواردت الأحداث على عقلي لتذكرني أنه لم يكن كابوسًا مضى وانتهى، حينئذ انتفضت من رقدتي متسائلة في جزعٍ:
-كيف جئت إلى هنا؟
تلفت حولي في تخوفٍ، فرأيت “فيجو” جالسًا أمامي على المقعد، انقبض قلبي وشحب وجهي لحظتها، رددت بصوتٍ متحشرج:
-أنت.
سألني وهو ينهض من موضعه:
-كيف تشعرين؟
ساد الاضطراب في كياني مع نظراته المثبتة علي، أجليت أحبال صوتي، وأجبته بصدرٍ ناهج:
-متعبة قليلًا…
رفعت يدي أعلى جبيني، وتساءلت بعد شهيقٍ سريع:
-ماذا حدث؟ وكيف وصلت إلي؟
أكد لي وهو يقف قبالتي:
-هذه مدينتي، أعرف كل شبر بها.
أطلت علي بقامته العالية، فنظرت إليه في توجسٍ قبل أن أدمدم:
-كانت هذه مؤامرة.
جلس على طرف الفراش مجاورًا لي، فبدا قريبًا، بل أقرب وهو يميل نحوي، ظلت نظراتي متعلقة به وهو يعقب:
-أعرف كافة التفاصيل…
علت بداخلي مشاعر الرهبة منه عندما أضاف بتباطؤ:
-لكن أنتِ…
لم أفوه بشيءٍ، وتجمدت نظراتي المرتاعة عليه، فصاح بي بنبرة تحمل اللوم:
-هل جننتِ؟ كيف تهربين وأنتِ حامل؟
عفويًا وضعت راحتي على بطني، كأنما أحميه من بطشه إن تطاول باليد علي، سألته وقلبي يدق بقوةٍ وفي غير هوادة:
-هل علمت بالأمر؟ من أخبرك؟
قبل أن يجاوبني قلت في صيغة تساؤلية:
-السيدة “كاميلا”؟
بدا وكأنه يقاتل لضبط انفعاله الحانق مني، فرد نافيًا بهدوءٍ مشحون وهو ينتصب في جلسته الملاصقة لي:
-لا، ليست هي.
سألته بترقبٍ، وكل نظراتي على قسماته المشدودة:
-من إذًا؟
احتدت نظرته ناحيتي وهو يخبرني:
-الطبيب “مارتي”.
ضاق ما بين حاجبي باستغرابٍ حينما رددت:
-من؟ وكيف ذلك؟
أفهمني بنبرة يشوبها الانزعاج:
-لقد ارتاب في شأنك، وقام بإجراء التحاليل للتأكد، وظهرت النتيجة الأولى إيجابية.
في التو دافعت عن نفسي قبل أن تدور برأسه الظنون:
-اقسم لك لم أخطط لذلك!
تأملني بنظرة شمولية أجفلتني، قبل أن يتابع متسائلًا:
-ماذا أفعل بكِ؟
حاوطت بطني بكلا ذراعي، وأكدت في توجسٍ حذر منه:
-صدقني، لم أكن على علمٍ بهذا.
همهم بشيء خفيض لم أستطع تفسيره، فتفرست فيه عن كثبٍ دون أن أتجرأ على سؤاله. امتدت يده بغتة لتمسك بفكي، ضغط عليه بإصبعيه هاتفًا:
-كدت أفقد عقلي عندما وصلني خبر هروبك.
زحفت العبرات إلى مقلتي وأنا أبرر رعونتي:
-كنت خائفة من ردة فعلك.
أرخى قبضته عن فكي الأسير، وقال بعد زفيرٍ ثقيل:
-أخبرتني “كاميلا” بهذا.
طارت الدمعات الوشيكة، ولمعت عيناي ببريق الارتياع عندما تساءلت:
-وماذا قالت لك أيضًا؟
سدد لي نظرة ذات دلالة غامضة وهو يجيب:
-تظن أنكِ قمت بخيانتي بعد كلامك السخيف معها.
اضطربت نبضات قلبي، وتسارعت كأني أخوض سباقًا للعدو. بالكاد كنت أتنفس وأنا أسأله:
-وهل صدقتها؟
قال ما تضمن في فحواه براءتي من أي شكوك:
-إن لم أكن واثقًا بكِ لما جعلتك زوجتي!!
رغم أن جملته منحتني قدرًا من الطمأنينة إلا أن القلق عاد ليسيطر علي عندما استأنف موضحًا:
-والأسوأ حينما علمت بنجاح مؤامرة اختطافك.
سألته ببلاهةٍ:
-هل كان ذلك مخططًا؟
ارتفعت رنة الغضب في صوته وهو يلومني:
-ماذا تظنين؟ أنتِ زوجة زعيم المافيا، لا رجل يعمل في وظيفة عادية، متوقع أن يحدث هذا، فأعدائي متربصون بنا.
اتفقت معه في الرأي، وتساءلت في فضولٍ مليء بالخجل:
-لكن كيف اكتشفت ذلك؟
مرر يده أعلى رأسه، وقال:
-منذ أن ذهبنا إلى الملهى الروسي، فهناك لاحظت وجود من يتبعنا.
هززت كتفي معقبة باستغرابٍ:
-أنا لم أشعر بذلك.
علق ساخرًا بشبح ابتسامة:
-لستِ محنكة مثلي، وأنا لا أتصرف بغباء كغيري.
احتوت عبارته على توبيخًا ضمنيًا، تقبلته مرغمة لأني أستحق ذلك، فالصدام الأخير كاد يودي بحياة اثنين: أنا، وجنيني. مرة أخرى عادت تعابيره للجدية وهو يشرح لي ما فعل لاحقًا:
-أرسلت أعيني لتقفي أثر من يحيك المؤامرة، وتبقي لي أن أعرف من ينقل الأخبار من الداخل، واليوم أمسكت به، ونال جزائه.
انزلقت أخبره بلا ترددٍ:
-إنه السائق، أليس كذلك؟
أكد لي ظني بإيماءة من رأسه، فلاحقته بسؤالي التالي:
-وماذا ستفعل الآن؟
جعل تعابيره غير مقروءة، ونظراته الموجهة لشخصي جامدة، فتساءلت بتلعثمٍ:
-هل .. ستقتلني؟ أم ستجبرني على .. التخلص منه؟
أجاب سائلًا إياي:
-أتظنين ذلك؟
تهدل كتفاي في خذلان وأنا أرد برأس مطأطأ:
-لا أعلم، حقًا لم أعد أعرف شيئًا، كل ما بي محبط وبائس، فأنت فعلت الأسوأ مع زوجتك الأولى.
أوضح لي مصيرها بكلمات جادة:
-هي من أقدمت على الانتحار بإدمانها للهيروين.
حملقت فيه مدهوشة، فأكمل بتعبير غير مكترثٍ:
-تناولت جرعة زائدة، فلقيت حتفها، وتركت الشائعات تنتشر دون أن أصححها، فصداها خدم مصالحي آنذاك.
الحديث عن رحيلها بغير شفقة جعل مشاعري تستثار، لاح الهم على وجهي، وانعكس الألم في صوتي وأنا أعقب عليه:
-أنت تهتم بما يدر عليك الربح المادي أو المعنوي بأي وسيلة، لذا لا أتوقع منك شفقة أو تعاطف في هذه المسألة…
شعرت بنظراته تذهب بعيدًا حين اختتمت كلامي بنبرة شبه منفعلة:
-فما الذي سيمنعك من تنفيذ تهديدك السابق؟
سكت، ومع طول سكوته أكد هاجسي الفزع، لهذا زادت الحدة في صوتي عندما أضفت:
-ربما ستنتظر حين ألد لتقتل الطفل، حتى تؤلمني بقسوة.
فيما يبدو آلمته بحقيقة مخاوفي تجاه أفعاله التي لا تغفر الذلل، رأيت كيف انقلبت سحنته، وغامت، فخفضت من عيني بانكسارٍ، وقد راح الدمع يتجمع فيهما، انتفضت لما هتف يأمرني:
-“ريانا”، انظري إلي.
طاوعته، وحدقت فيه بنظراتٍ تفتش عن إنسانيته الضائعة، بادلني نظرة طويلة غير مفهومة، قبل أن يبدد الصمت الثقيل بسؤالٍ أغرب:
-ألا تثقي بهنا؟
وأشار إلى موضع قلبه، فتسمرت نظراتي في ذهول عليه، خفق ما بين ضلوعي في توترٍ، وهو يمسك بيدي ليضعها على صدره، عاودت التحديق في وجهه بتحيرٍ، فاعترف لي بنزقٍ صدمني:
-أنا لا أعرف كيف أخبرك بهذا، ولكني أحبك.
تدلى فكي للأسفل وأنا أردد:
-ماذا؟
شعرت بدقاته تحت يدي، فغمرتني موجات من الدفء المغري، استمر “فيجو” يسهب في البوح بما التاع الفؤاد لسماعه:
-قد لا أجيد التعبير عن العواطف كباقي البشر؛ لكن هناك ما تغير بي بسببك.
خفقة وراء الأخرى عصفت بي، حتى شعرت بكلي يرتج، اضطربت أنفاسي وهو يزيد من اعترافه غير المتوقع:
-أنتِ تركتِ أثرك يتغلل في نفسي، رغم ما مررت به من قساوة وبغض في طفولتي.
سألته بلا تصديقٍ:
-أهذه خدعة جديدة؟
وقبل أن ينطق بكلمة رجوته باستعطافٍ شديد:
-من فضلك توقف، لا تعلقني بالأوهام!
اشتدت قبضته على يدي الملاصقة لنبض قلبه، وسألني في عتابٍ:
-ألم تتعلمي الدرس؟ أنا لا أكذب فيما أقول.
تصدع قلبي مرة، ولن أستطع لملمة حطامه مجددًا إن ثبت أنه يلاعبني، علقت غصة مؤلمة بحلقي، وثارت الدموع في عيني وأنا أخبره:
-لكن هناك عشيقاتك وآ…
وضع إصبعه على شفتي ليسكتني قائلًا بصوتٍ شبه خافت:
-توقفي عن ترديد ذلك الكلام السقيم، فأنا لم أقرب أنثى منذ اللحظة التي رأيتك فيها، في حفل الزفاف.
فاضت الدموع بتدفقٍ من طرفي وأنا أسأله بلسانٍ يلهج:
-كيف؟ وما كنت أراه وأسمع عنه؟!!
ترك يدي واحتضن وجهي براحتيه مزيحًا ما بلل بشرتي، ليقول بعدها باسمًا:
-إنه “لوكاس”، يحب اللهو، أما أنا فمنضبط فيما يخص النساء، فلم تستهويني إلا واحدة.
اهتز قلبي وطاح في الأفق الحالم وهو ينطق:
-هي أنتِ.
توقفت عن التنفس لهنيهة، وشردت غير مستوعبة ما يتوالى علي من اعترافات تمنيتها حتى فقدت الأمل في حدوثها، أعادني من سرحاني الحالم بقبلة حسية ناعمة، ليتابع بعدها برغبة متقدة:
-أنا أريدكِ فقط.
تناوبت علي مشاعري المضطربة كأنها تتصارع في معركة خاصة بالوجدان. انتحبت، وتوسلته في صوتٍ مختنق شبه باكٍ:
-أرجوك، لا تلعب بعواطفي، لن أتحمل.
أسبل عيناه تجاهي مرددًا بخفوت:
-“ريانا”، أنا أحبك.
كم كابدت من انتظار ومعاناة لأصل لهذه اللحظة الفارقة! ما زالت على صدمتي، فقلت مستنكرة:
-مستحيل، أنت.. أنت لا تعشق أحدًا!
بأيسر المفردات وأعذبها أكد لي:
-قد يبدو هذا للجميع صحيحًا، أنا لم أؤمن بالحب ومسمياته قبل سابق، وأعرف أن علاقتنا بدأت كصفقة لقمع التمرد بين صفوف جماعتنا الإيطالية؛ لكن ما أنا متأكد منه الآن، أني أريد تمضية القادم من حياتي معك.
بهرني بصدق عباراته، فعادت الدموع تنساب بغزارة من عيني، شهقت من فرط تأثري الفرح، فضمني إليه مزيدًا في الكلام:
-لست واثقًا إن كنت سأنجح أم لا؛ لكني سأحاول…
أحسست بأنفاسه تلفح جانب عنقي فسرت الرعدات في ظهري، لتغذي بي هذا الشعور العميق بافتناني الوله به، تأوهت بتنهيدة بطيئة مع لمساته الناعمة، قبل أن يتبع ذلك بعهده الهامس:
-أعدك بذلك، سأمنح علاقتنا كل الفرص لتكون مستقرة وطبيعية.
يبدو أن سلطان الهوى في النهاية قد طغى وتسيَّد رغم العراقيل، عانقته بقوةٍ، كأني لا أريد فراقه، وطلبت منه فيما يشبه الرجاء:
-لا خيانة “فيجو”!
زاد هو الآخر من عناقه لي، وقال في لطافةٍ غريبة:
-لا خيانة زوجتي الحبيبة.
انسللت من حضنه الدافئ لأنظر إليه هاتفة وأنا أكفكف دمعي:
-وهذا يكفيني الآن.
هذه المرة انحنيت على شفتيه مبادرة بتقبيله، فالتقم خاصتي بتوقٍ نهم جعل أنفاسي تنقطع، بصعوبة حرر وجهي فابتسمت في رضا ظفرت به أخيرًا، لأخبره بعدها بنظراتٍ اشتعلت بوهج الرغبة:
-فأنت رغم كل شيء لم تعد غير قابلٍ للحب.
وصلت معه بعد مشقة وعناء إلى نقطة البداية في علاقتنا الجادة، لا مزيد من الإنكار أو الهروب، قد لا أضمن ما يضمره لنا المستقبل المجهول من تحدياتٍ صعبة وعسيرة، ربما تطيح بنا هنا وهناك؛ لكن مع اتحادنا الروحي والجسدي سنقدر معًا على مجابهة أي شيء. كما أننا سنسعى لإرساء أول لبنة في بناء أسرة مستقرة، رغم قساوة ووحشية عالم الظلام الذي نعيش في ظلاله.
هذا كان جانبي المروي من القصة، بما احتوته من مشاعر عميقة وخواطر كثيرة .. فماذا عن جانبه غير المعلوم؟!!
-تمت-
لقراءة الرواية كاملة اضغط على : (رواية غير قابل للحب)
